 03-02-2016, 03:50 PM
03-02-2016, 03:50 PM
|
#3
|
|
الاداره
|
بيانات اضافيه [
+
]
|
|
رقم العضوية : 2827
|
|
تاريخ التسجيل : Nov 2012
|
|
أخر زيارة : 01-26-2018 (06:12 AM)
|
|
المشاركات :
36,614 [
+
] |
|
التقييم : 10
|
|
الدولهـ
|
|
الجنس ~
|
|
SMS ~
|
|
|
لوني المفضل : Brown
|
|

ب- اللُّبّ:
العقل الخالص من الشَّوائب، وقيل: ما ذكا من العقل، فكلّ لبٍّ عقل ولا عكس؛ ولهذا علَّق الله الأحكام التي لا تُدركها إلاَّ العقول الذكيَّة بأولي الألباب[47].
واللب هو القلب الخالص، وخالص القلب، ويكنى به عن العقل لأنه خالص القلب والخطاب موجه له، واللبيب العاقل، وألبَّ به لبَّا، إذا أقام به، والملبوب: الموصوف بالعقل[48].
فأصل اللُبّ من أَلَبَّ، وهو كاللَّب - بالفتح - بمعنى الملازم، وبالضم بمعنى الخالص من كل شيء، وهو قلب كل شيء وعقله[49].
فخالص كل مادة قلبها، وخالص القلب في الإنسان عقله، لذا فُهم اللب في الإنسان على أنه عقله، فسمي العقل لُبًّا؛ وذلك لأن الخطاب يوجه لقوَّة واحدة من بين قوى القلب، وهي القوَّة العاقلة – أي: العقل - فاللبّ أصل يدور على معاني اللزوم والثبات وعلىخلوص وجَوْدَة[50].
ورد لفظ اللبّ في القرآن الكريم في صيغة الجمع المضاف لاسم الإشارة؛ دلالة على الاختصاص والاستحقاق، مثل ذاك قوله تعالى: {وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ} [يوسف: 68]؛ أي: صاحب علم، وهذا أرفع من لفظ "عالم"؛ لاختصاصه بالعلم دون غيره.
وفي ورود اللبّ بصيغة الجمع نكتة بلاغية - ذكرت في الفصل الأوَّل - فائدتها انتفاء الثقل في النطق.
\باستقراء آيات اللبّ في القرآن نلاحظ تخصيصه بأمور منها:
1- منح أولي الألباب صفات خاصَّة بهم دون غيرهم، وأخرى شرط في انتسابهم لهذه الخاصية، منها الإيمان والهداية، والتقوى والعلم، والتفكر في خلق الله تعالى، والتدبر في وحيه.
\{يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُوا الأَلْبَابِ} [آل عمران: 7]، {هُدًى وَذِكْرَى لأُوْلِي الأَلْبَابِ} [غافر: 54]، {وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُوْلُوا الأَلْبَابِ} [إبراهيم: 52]، {فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة: 100]، {لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الأَلْبَابِ} [ص: 29].
2- التذكر والعبرة صفة خاصَّة خالصة لأولي الألباب؛ {وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُوا الأَلْبَابِ} [البقرة: 269]، وفي [آل عمران: 7]، وقوله: {وَذِكْرَى لأُوْلِي الأَلْبَابِ} [ص: 43]، و [غافر: 54].
أمَّا الاعتبار: {لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأُوْلِي الأَلْبَابِ } [يوسف:111]، وإن لم تكن خاصًّا بهم وحدهم فهي كذلك لأولي الأبصار.
والتذكُّر كان في جميع الآيات أعلى من درجة التفكر، وهذه عملية تكون في الآيات الكونية، يليه التدبر في الآيات المتلوَّة، كما أنَّ التذكّر من أعلى مراتب العلم، وهو من أعلى مراتب الإيمان؛ لقوله تعالى: {وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ}، بعدها: {وَلِيَذَّكَّرَ أُوْلُوا الأَلْبَابِ} [إبراهيم: 52].
فليس كلّ مَن علِم يتذكَّر، غير أنَّ كلَّ متذكِّر ضمنًا هو عالم بما تذكَّر.
وقوله: {يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُوا الأَلْبَابِ} [آل عمران: 7]؛ فليس كل مَن آمن يتذكَّر؛ لأنَّ التذكّر مرتبة لاحقة تدلّ على زيادة الإيمان عن درجته الأولى.
فالقلْب خصَّ بالفقه والعقل، واللّبّ خصَّ بالتذكّر، والفؤاد بالرؤية.
فاللّبّ يمثّل خالص القلْب، بل خالص العقل، والتذكّر أعْلى من الفقه والتعقّل والرؤية، ومن التفكّر؛ لذا نجد في آية القصاص: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ} [البقرة: 178]، فكان هنا لا بدَّ من طرح سؤال، وهو: كيف يليق بكمال رحمتِه إيلام العبد الضعيف؟
لأجل دفع هذا السؤال؛ ذكَرَ عقب بيان أحكام القصاص حكمةَ تشريعه، وهي ضمان بقاء الحياة للذين يقيمون حدود الله، وهذه ما يعقِلُها إلاَّ أولو الألباب؛ لإبصارهم العواقب من تَجاربهم في الدنيا، وفهمِهِم لسلوك النَّاس وعادات مجتمعاتِهم، ويعلمون أثر الخوف من العقاب، والرَّدع الناتج من ذاك، فإذا أراد أحدٌ الإقدام على قتل آخر عدوٍّ له، وعلم أنَّ القصاص سيقع عليه، صار ذاك رادعًا؛ لأنَّ العاقل لا يريد إتْلاف نفسه بإتلاف غيره، فإنْ خاف ذلك كان خوفه سببًا للكف ودوام الحياة له ولغيره، وقطعًا للثأر، فمن لا عقل له يهديه إلى هذا لا يخاف ولا يدرك سرَّ الأحكام؛ لذا خصَّ الله تعالى أولي الألباب بإدْراك الحكمة من تشريعِه.
فالتذكّر والتفكّر منزلان يثمِران أنواع المعارف، وحقائق الإيمان والإحسان، والعارف لا يزال يعود بتفكره على تذكُّره والعكس؛ حتَّى يفتح عليه.
فالتفكر التماس الغاية من مبادئها، وهو تلمّس البصيرة لاستدراك البغية، أمَّا التذكّر فوجود، فهو تفعل من الذكْر ضد النسيان؛ أي: حضور المذكور من الصور العلميَّة في القلب، واختير بناء التفعّل لحصوله بعد مهلة وتدرّج كالتصبر والتفهّم والتعلّم[51].
فيكون بذلك أولو الألباب هم خلاصة ذوي العقول، فهم من يستحضرون العلوم بعد التفكر والتبصّر فيها وحفظها، فيتجلى لهم ما لا يطلع عليه غيرهم.
3- أولو الألباب هم خاصَّة عباد الرحمن الذين أقبلوا على طاعته، وتزوَّدوا بالتقْوى، وآمنوا وعلموا، ثمَّ تفكَّروا وتدبَّروا، فخصَّهم الرحمن بإدراك أسرار التَّشريع، وحِكم الأحكام دون غيرهم؛ {وَلَكُمْ فِي القِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 179]، وقال {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ}[52] [البقرة: 197]، {يُؤْتِي الحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُوا الأَلْبَابِ} [البقرة: 269].
فهُم ذوُو الحكمة والرسوخ في العلم؛ لذا ناط بهم خاصيَّة التذكّر؛ لأنَّهم اختصُّوا دون غيرهم باللّبّ، وإذا قيل: إنَّ اللُّبَّ هو العقل، فهنا إشكال وهو: إذا كان لا يصح خطاب إلا العقلاء، فما الفائدة في قوله "أولي الألباب"؟ هنا يعلم أنَّ اللب هو العقل الخالِص من الشوائب، وليس كل صاحب عقل صاحب لب، كما أنَّ الخطاب في الآية كان المراد منه التَّنبيه على أولي الألباب بأنَّهم تلحقهم لمكانتهم العلميَّة تبعة المحاسبة والرّقابة، فهم أعْلم النَّاس بمراد الله تعالى، فكان لا بدَّ لهم أن يكونوا أسبق النَّاس عملاً بذاك العلْم، وإعراضهم أقْبح من إعراضِ غيرِهم؛ لعظم الحجَّة القائمة عليْهِم مقارنة بغيرهم.
ج- الأبصار:
وهي البصيرة، وقد وردت بصيغة الجمع في قوله تعالى: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لأُولِي الأَبْصَارِ} [آل عمران: 13]، قال الراغب: يقال لقوَّة القلب المدركة: بصيرة، ولا يكاد يقال للجارحة: بصيرة، وقلَّما يقال: بَصُرت في الحاسَّة، إذا لم تضامّه رؤية القلب[53].
ولأنَّ البصيرة كانت بمعنى قوى الإدراك نجد تفسيرها لا يتجاوز ذلك، قال الطبري في معنى "لأولي الأبصار": ممَّن له فهم وعقل[54].
والبصيرة فعلها ووظيفتها التبصر، وهذه درجة قبل التذكر؛ فهي نور في القلب يبصر به، فيقوم في قلبه شواهد الحق، ويرى حقيقة ما يبلغه ويخبر به عن طريق الرسل، فالبصيرة ما خلصك من الحيرة، إما بإيمان أو عيان.
قال ابن القيم عن صاحب "المنازل": "البصيرة ما يخلصك من الحيرة، وهي على ثلاث درجات:
الأولى: أن تعلم أنَّ الخبر القائم بتمْهيد الشَّريعة يصدر عن عين لا يخاف عواقبها، فترى من حقِّه أن تؤديه يقينًا، وتغضب له غيرة.
والدَّرجة الثانية: أن تشهد في هداية الحقّ وإضلاله إصابة العدل.
والدَّرجة الثَّالثة: تفجر المعرِفة، وتثبت الإشارة وتنبت الفراسة[55].
والله جعل العمى للعَين عدم إدراك المرئيات واستقبال الصور، والجهْل عمى القلب؛ أي: فقدان لبصيرته؛ {وَلَكِنْ تَعْمَى القُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ} [الحج: 46]؛ أي: الإدراك التام إنَّما يكون بالقلب وتعطّله بعمى القلب، والعمى لا يطلق إلا على البصر، فكانت الأبصار في "أولي الأبصار"، فهي إحدى قوى القلب لرؤية الحق وفهم الحجة؛ فالعمى هنا أصاب بصيرة القلب.
وفي آية النور كان السياق يدل على طلب النَّظر في الآيات المشاهَدَة؛ لإدراك الحقيقة واتباع الحق، تأمل قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَاباً ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَاماً فَتَرَى الوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالأَبْصَارِ * يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لأُوْلِي الأَبْصَارِ} [النور: 43، 44]؛ أي: ألم تر وتنظر متأمِّلاً إلى ما حولك من المشاهد، التي منها سَوْق السحاب المتفرق وجمعه ثم إنزال المطر الغيث منه، فينزل خيره على من يشاء الله، ويمتنع عمن شاء، على مقتضى حكمته - جل وعلا؟!
ثم قال "يقلب الليل والنهار"، وهذه حركة الزَّمن المشاهَدة بالعين الباصرة، فكان فيها عبرة لذوي البصائِر؛ وهي: القلوب النافذة للأمور المطلوبة منها، كما تنفذ الأبصار إلى الأمور المشاهدة قبلاً، فكانت القلوب مبصرة بتفكرها وتدبرها، فالبصر لا يعمى عن مشاهدة الآيات المخلوقة من سحاب ومطر، ونبات ينمو، وأرض تُسْقَى، وأخرى يُحبَس عنها القطر، وتداول الأيام، وتتابع اللَّيل والنَّهار.
\لكنَّ القلوب بصائرُها تعمى عن إدْراك المغزى من المبصرات، وفهْم الرسالة الموجَّهة من الخالق، عبر عظمة مخلوقاته؛ لذا نجِد قوله تعالى: {فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ * أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى القُلُوبُ الَتِي فِي الصُّدُورِ} [الحج: 45، 46].
فمجرَّد سماع القصص، ورؤْية الآثار، والعلم بالأُمم الخالية التي عوقبت لإعراضها، لا خير يرجى من ذاك ما لَم يكن معه عبرة توصل إلى التوبة والتقوى؛ لذا بيّن تعالى أنَّ العمى الضَّارَّ هو عمى البصيرة؛ لأنَّها قوة فقه العبر، والنفاذ إلى المغزى، والتيقُّن من الحق، والطمأنينة بالمعاينة القلبيَّة؛ لذا بعدها يكون التذكر؛ لقوله تعالى: {تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ} [ق: 8]، فالتبصُّر آلة البصر، والتذكرة آلة الذكر، وهما للعبد المنيب التائب، فيبصر مواقع الآيات، ومحال العبر؛ فيزول عنه العمى والغفلة فيتذكر؛ لأنَّ التبصُّر يوجب حصول صورة المدلول بعد الغفلة عنها، فيتذكَّر فيكون من أولي الألباب، وهم أعلى من أولي الأبصار؛ لذا قيل: إن الله يحب ذا البصر النافذ عند ورود الشبهات، والعقل الكامل عند حلول الشهوات.
نخلص إلى أنَّ البصيرة خصَّت بالعبرة، واللّبّ خصَّ بالتذكّر، فالبصيرة نورٌ في القلْب؛ لقوله تعالى: {أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى القُلُوبُ الَتِي فِي الصُّدُورِ} [الحج: 46]، فأمر بالسياحة في الأرض، وتأمّل آثار الأمم الغابرة، وما حل بها بعد أن عمرت في الأرض قرونًا، فذكر ما يتكامل به الاعتبار؛ لأنَّ الرؤية لها حظٌّ عظيم في الاعتبار، مع الاستِماع لقصص مَن مضى، ولكن لا يكمل الأمر إلاَّ بالتدبُّر بالقلب، "وعقل ذلك؛ بأن يعقل التَّوحيد بما حصل له من الاستِبْصار والاعتبار"[56].
فيكون له قلب يعقل به وأذن يسمع بها؛ لأنَّه إن لم يسعه داعي الاستقلال بالتفكير، وسعه داعي الاستماع والاستجابة للواعظ.
ثم لما كان التعقل والسمع في الحقيقة من شأن القلب؛ أي: النفس المدركة، وهو الذي يبعث الإنسان إلى متابعة ما يعقله أو يسمعه من ناصحه، عدَّ الله تعالى إدراك القلب رؤية له ومشاهدة، ومن لا يعقل ولا يسمع أعمى القلب[57]، كأنه قال تعالى: لا عمى في أبصارِهم فإنَّهم يروْن بها، لكن العمى في قلوبهم[58].
د- الصدر:
وهو أعلى ومقدَّم كل شيء وأوله، حتَّى إنَّهم يقولون: صدر النَّهار والليل، وصدر الشتاء والصيف[59].
والصدر من الإنسان والحيوان: ما دون العنُق إلى فضاء الجوف، وعند الأطبَّاء: قفص عظمي غضروفي يتضمَّن الآلات الرئيسة للتنفُّس والدَّورة[60].
ورد الصَّدر في القرآن الكريم "44" مرَّة، نسبت له فيها أفعال وصفات يكتسبها، دلَّت على أنَّ له دورًا في الجانب المعرفي، وأنَّه ذو علاقة مع القلب مركز الإدراك، بل بعض الصِّفات التي نسبت للصدْر هي من صفات القلب؛ لذا قال بعض الحكماء: حيثما ذكر الله تعالى القلب فإشارة إلى العقل والعلم، وحيثما ذكر الصَّدر فإشارة إلى ذلك وإلى سائر القُوى من الشَّهوة والهوى والغضب[61].
فالصَّدر حاوٍ للقلب، والقلب حاوٍ للفؤاد، والفؤاد حاوٍ للُّب، "فالصدر بالنسبة للقلب بمنزلة بياض العين في العين، ومثل صحن الدار في الدار، ومثل الذي يحوط بمكة.. فهذا الصدر موضع دخول الوسواس والآفات كما يعيب بياض العين آفة البثور وسائر علل الرمد"[62].
وهو موضع الشهوات، والحاجات، والأماني، وولاية النفس الأمارة بالسوء، والوساوس، وهو موضع الإسلام، وحفظ العلم المسموع من أحكام وأخبار.
عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا ينزع الله العلم من صدور الرجال، ولكن ينزع العلم بموت العلماء، فإذا لم يُبق عالمًا اتَّخذ الناس رؤساء جهالاً، فقالوا بالرأي فضلّوا وأضلّوا))[63].
فلا انفِكاك بين الصَّدْرِ والقلب، غير أنَّ لكلّ واحد صفات مغايرة مع الاشتراك في أخرى، فهو مقدّمة القلب، ومنْه يصدر الوسواس والخواطر نحو القلب.
|
|
|
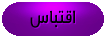
|